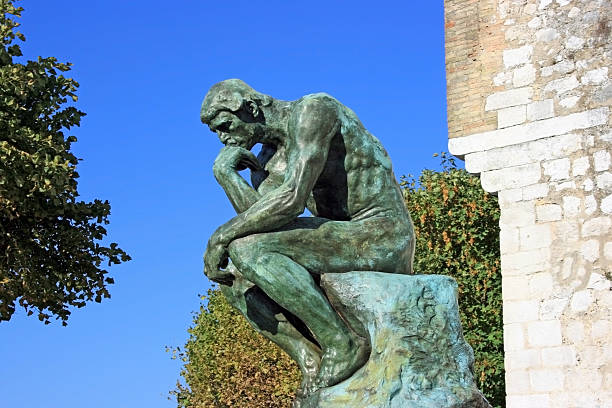تصوُّر اللغة على أنها شيء نغازله ونتعارك معه، وليس كلمات جامدة يضمها قاموس، يساعدنا أيضًا على حل سؤال حفلات السَّمَر عمّا إذا كان بالإمكان ترجمة كل شيء.
ما الذي يفعله المترجم؟
ماكس نورمان
ترجمة: أحمد طارق عبد الحميد
نشر المقال في مجلة ذا نيويوركر 7 ديسمبر 2024
في “سباعية” جون فوسه عن الفن والإله، وهي الرواية التي أهّلته للفوز بجائزة نوبل في العام الماضي، يبرُزُ رجلان وكلب. الرجلان كلاهما رسام، ولهما بشكل مربكٍ الاسم نفسه: أسله [Asle]. أما الكلب فلا لبس فيه: يُدعى براجي [Bragi]. عينه كحلاء متفهمة لكل شيء، ويرافق أسله الأول، وإن كان مِلك أسله الآخر المريض الذي لا يستطيع الاعتناء به. ويتدفق السرد بكسل في الرواية، أشبه ما يكون بالحياة الواقعية، لا يفصل بين أجزائه إلا براجي كلما احتاج إلى الخروج لقضاء حاجته، أو بعدما يلعق إناء الماء حتى الجفاف، أو عندما يقع -بوتيرة مضحكة وإن كانت إلى حد طفيف مزعجة- كلما وقف أسله ناسيًا أن الكلب راقد على حجره. إن حب أسله الفظّ لبراجي، وقربُه الجسدي من الكائن الصغير، مكتوب بإحساس بسيط تستشف من خلاله أن فوسه، من بين خصاله الأخرى، يحب الكلاب.
يُكتب اسم براجي في الأصل النرويجي Brage (ويُنطق بروجه). أما المسؤول عن النطق الجديد [Bragi بإضافة حرف I في نهاية الكلمة]، فهو داميون سيرلز مترجم أعمال فوسه. وBrage هو إله الشعر النرويجي، المعلومة التي غابت عن سيرلز حتى أخبره بها فوسه، لأن من العادة كتابة اسم هذا الإله في الإنجليزية بحرف I. ويبرر سيرلز اختياره بأنه لو كان استخدم كتابة الاسم النرويجية، فربما دفع القراء الناطقين بالإنجليزية للظن بأن الكلمة على وزن rage [ثورة غضب] أو page [صفحة]، وهي بشكل واضح كلمات غير لطيفة ولا تناسب كلبًا لطيفًا جدًا مثله. أما استخدام النسخة الإنجليزية المميزة فقد يساعد الذين يعرفون الاسم على إدراك الصلة بينه وبين الأسطورة، كما أنها تتميز بالسجع مع doggie [دوجي/ كلبوب]، إذا لم تدقِّق. “لن أعرف ذلك يقينًا، لكنني مقتنع بأن قراء اللغة الإنجليزية لم يكونوا سيحبون Brage بقدر ما يحبون Bragi وأن تغيير الاسم كان إحدى أفضل قرارات الترجمة التي اتخذتها في هذه الكتب”، هكذا يكتب سيرلز في مقاله عن حرفته “فلسفة الترجمة” (Yale).
كأن الترجمة هي أضعف أبناء الأدب، يُنظر إليها غالبًا باعتبارها عملًا شاقًّا مملًا أكثر منها عملًا فنيًا. ولا يكاد يلتفت أحد إلى ممارسيها لشيء غير الفشل الذريع، وسيوافق كثيرون على رأي جورج إليوت أن “المترجم الجيد لا يرقى أبدًا إلى مستوى كاتب الأعمال الأصلية الجيدة“. (كانت إليوت نفسها تترجم عن الألمانية واللاتينية). وجاء كتاب جورج ستاينر الفوضوي والعبقري “بعد بابل” [After Babel] ليكون أول معالجة شاملة لهذا الموضوع عندما نشره عام 1975. لقد حقّقت بعض الترجمات بالفعل شهرتها الخاصة، وكذلك بعض المترجمين -ترجمة آرثر جولدنج لأوفيد، وألكساندر بوب لهوميروس، وت. ك. سكوت مونكريف لبروست- لكن عنوان رسالة لورنس فينوتي الفارقة “اختفاء المترجم” The Translator’s Invisibility 1995 يظل يلخص تاريخ الترجمة إلى حد كبير.
تشير التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن 3% من الكتب المنشورة سنويًا عبارة عن ترجمات، وبحسب إحدى الدراسات فإن أقل من 5% من الكتب المعروضة في مراجعات New York Times Book Review تكون مكتوبة في الأصل بلغة غير الإنجليزية. لكن ظهور المترجمين في المجال العام صار متزايدًا. فأصبح ريتشارد بيفير ولاريسا فولوكونسكي عَلَمَان أدبيان بترجماتهما للكلاسيكيات الروسية، وكذلك آن جولدستاين بترجمتها إيلينا فيرانتي، وإديث جروسمان بترجمتها “دون كيخوته”. وأفردت مجلة The New Yorker قصة شخصية عن إميلي ويلسون، أول مترجمة أنثى للأوديسة إلى الإنجليزية، وكذلك كتبت عنها كل الوسائل الإعلامية الأخرى تقريبًا. وأصبحت أصوات المترجمين أعلى أيضًا. ففي عام 2021، أعلنت جينيفر كروفت، المترجمة الإنجليزية لروايات البولندية الحائزة على نوبل أولجا توكارتشوك، أنها لن توافق على ترجمة كتاب ما لم يوضع اسمها على الغلاف الخارجي. وكتبت على تويتر “إن إغفال الاسم لا يعبر عن قلة احترام لي فحسب، بل هو أيضًا إساءة للقارئ الذي يجب أن يعرف مَن الذي يختار الكلمات التي سيقرأها”.
وقد ظهر نوع فرعي جديد من الكتب يكتبه المترجمون عن الترجمة، يتضمن بيانات مثل كتاب إديث جروسمان “لماذا الترجمة مهمة” Why Translation Matters 2010 وكتاب مارك بوليزوتي “تعاطفًا مع الخائن” Sympathy for the Traitor 2018، ودراسات نظرية مثل دراسة ديفيد بيلوس “أتلك سمكة في أذنك؟” Is That a Fish in Your Ear? 2011، ومقالات سِيَريّة مثل كتاب كيت بريجز “هذا الفن الصغير” This Little Art 2017 وكتاب بولي بارتون “خمسون صوتًا” Fifty Sounds 2021 وكتاب دانيل هاهن “إشعال النار: يوميات مترجم” Catching Fire: A Translation Diary 2022. بل إن كروفت قد نشرت في بداية هذا العام “تلاشي إرينا راي” [The Extinction of Irena Rey]، وهي رواية عن اجتماع (بابل؟) للمترجمين الأدبيين الذين يشرعون في البحث عن المؤلفة التي يترجم كلُّ واحد منهم عملَها إلى لغة مختلفة.
أما سيرلز، الذي يترجم عن الألمانية والهولندية والفرنسية بالإضافة إلى النرويجية، فلا يقدم اعتذارًا أو نظرية أو تاريخًا، بل “فلسفة” للترجمة. وبدقة أكبر، فهو يقدم “دراسة لظاهرة” [phenomenology] الترجمة، مستعيرًا المصطلح الذي أذاعه الفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي. ودراسة الظاهرة ليست دراسة للكيفية التي قد ندرك بها العالم بشكل تجريدي -فكّر في طريقة تنظير رينيه ديكارت للفجوة المطلقة بين العقل والجسد- بل لدراسة تجربتنا الفعلية للعالم. إن الترجمة عند سيرلز مرتبطة بدراسة الظاهرة لأنها تقوم بالأساس على تجربة: تجربة المترجم في قراءة الأصل، الذي تُعاد صياغته بعد ذلك لقارئ جديد. الترجمة “شيء يشبه التحرك في العالم، ولا يشبه على الإطلاق الاختيار من قائمة خيارات”. يكتب سيرلز، “لا توجد قواعد، بل قرارات فقط”.
“الترجمة” [translation] لم تكن دائمًا وسيلتك لقول ترجمة. ففي اللاتينية، وهي أول لغة غربية تُرجمت إليها الكتب بشكل مُكثف، يمكنك أن “تحوّل” (vertere) نصًا، أو “تنقله كلمة بكلمة” (verbum pro verbo reddere). كان الاسم translatio يشير بالأساس إلى نقل مادي، كما نستخدمه [في الإنجليزية] حتى الآن للإشارة إلى “نقل” الرفات البشري [translation of human remains]. أما المصطلح اللاتيني الحديث traductio، أصل الكلمة الفرنسية traduction والإيطالية traduzione والإسبانية traducción، فيبدو أنه اكتسب معناه الحالي من ليوناردو بروني، مؤلف الرسالة المؤثرة عن الترجمة عام 1424. وتقول القصة إن المفكر الإيطالي الإنسانيّ المذهب قد أساء بشكل طفيف فهم معنى الفعل traducere، الذي يرد في نص روماني قديم كان يقرؤه، ويشير إلى معنى أقرب إلى “يستمد من”. هذه المفارقة، وإن كانت مناسبة، فهي على الأرجح أفضل من أن تكون حقيقية.
ولا يقتصر الأمر على أن الترجمة كانت تُسمى شيئًا آخر: بل وكانت تعني شيئًا آخر. فبحسب سيرلز، الذي يعتمد بشكل كبير على مُنَظِّر القرن العشرين الفرنسيّ أنطوان بيرمان، فإن الترجمة كانت مسألة مضمون في البداية، ولم تصبح مسألة شكل إلا لاحقًا. كان شيشرون يعتقد أن المعنى يجب أن يُترجم إلى معنى، فلا يجب “عد الكلمات للقارئ”، بل “وزنها”. بعد ذلك ببضعة قرون، سيذهب القديس جيروم، مؤلف ترجمة “فولجات” اللاتينية العظيمة للكتاب المقدس، إلى أن ترجمات الأسرار المقدسة يجب أن يكون كلمة بكلمة، لكن ما عدا ذلك يجب أن يكون، كما دعا شيشرون، معنى بمعنى. كانت العصور القديمة حتى عصر النهضة تتحلى بثقة عفوية في أن الترجمة ممكنة فعلًا، ولكن اللغة الأحدث عهدًا قد تحتاج إلى الاتساع حتى تستطيع استيعاب ثراء دلالات الأصل وسلطته الكلاسيكية.
بحلول الفترة التي اكتشف فيها كولومبوس العالم الجديد، بدأت الترجمة تتخذ مداها المعاصر تقريبًا. يكتب سيرلز “صار الهدف من الترجمة العمل، بوحدته التي لا انفصام لها من مضمونٍ وشكل، جسمٍ وروح، وصارت الترجمة هي مهمة الحفاظ على روح الأصل أو جوهره في جسد جديد تمامًا”. وتزايدت الترجمة بإفراط في عصر النهضة، عندما أعاد أصحاب المذهب الإنسانيّ اكتشاف اللغة الإغريقية القديمة، وترجموا عنها بغزارة إلى اللاتينية، وبدأوا نقل الأدب والفلسفة والتاريخ إلى الألسنة التي تتحدث بها أوروبا. في ذلك الوقت نفسه، قام المُصلِحون الدينيّون، مثل ويليام تيندال ومارتن لوثر، ولاحقًا لجنة المترجمين التي شكّلها الملك جيمس، بترجمة الكتاب المقدس إلى لغة الحياة اليومية للناس.
المترجمون عندئذ كانوا يخاطرون بشكل أكبر من اليوم: كتابة رأي سيء في الترجمة كان آخر ما قد يشغل أحدهم. ففي عام 1536، أُعدم تيندال حرقًا. وبعد عشر سنوات، كان إيتيان دوليه، المترجم الفرنسي وأحد الُمَنظِّرين الأوائل لذلك الفن، قد اتُّهم بالهرطقة بسبب ترجمته أفلاطون، فشُنق، وإذا لم يكن كلامي واضحًا حتى الآن فقد أحرقوه أيضًا. إنهم، كما يشير مارك بوليزوتي، شهداء الترجمة الأوائل [في التاريخ الأوروبي]. ولم تكن المشكلة أن ترجماتهم رديئة، بل بالأحرى أن ترجماتهم كانت تزعزع ما يشبه احتكار الكنيسة الكاثوليكية لقراءة النص المقدس وتفسيره، أو كانت تتحدى بشكل مباشر عقائد الكنيسة الجامدة. لكن في الوقت نفسه، كانت الترجمة -من لغات محلية أولًا مثل العبرية والإغريقية إلى اللغة اللاتينية العامة- قد ساعدت الكتاب المقدس على الانتشار إلى مناطق أبعد من أصوله المحلية. من البداية، كانت الترجمة نوعًا ما صفقةً فاوستيّة.
تغيّرت الأمور، كما يحدث عادة، مع المزيج الروحي الذي قدمته حركة “العاصفة والاندفاع” في ألمانيا، نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر. ربط الرومانسيون الألمان فكرة “اللسان الأم” بـ”العرق” والدولة القومية الناشئة. وكان رأيهم أن اللغة تطورت من وسائل تعبير بحتة إلى وسائل “يشكّل بها الإنسان نفسه والعالم في آنٍ واحد” بحسب صياغة فيلهلم فون همبولت، المترجم واللغوي أخو ألكسندر. من هنا تبدأ المخاطر الأيديولوجية الحديثة للترجمة، باعتبارها عملية محفوفة بالمخاطر لنقل كلام شخصٍ عالِقٍ في نسيجٍ ثقافيٍّ فريد.
وكذلك يبدأ الإطار الأساسي الذي لا يزال يستخدمه المُنَظِّرون، وكثير من المترجمين والنقاد في الواقع. وتمثّل محاضرة فريدريك شلايرماخر عام 1813 “عن الطرق المختلفة للترجمة” لحظةً فاصلة. يقول هذا الفيلسوف الألماني “المترجمُ إما يترك المؤلفَ على حاله بقدر الإمكان ويحرّك القارئَ نحوه، وإما يترك القارئَ على حاله بقدر الإمكان ويحرّك المؤلفَ نحوه”. الترجمة، من وجهة النظر هذه، شد حبل في أفضل الأحوال، ولعبة محصلتها صفر في أسوأها. ويسمي لورنس فينوتي هذين البديلين “توطين” و”تغريب”. ترجمة “التغريب” -التي تقرّبك إلى النص، ولا تترك لك فرصة لتنسى أنها ترجمة- قد تربك القارئ بشكل فعّال لكنها قد تنفّره أيضًا، أما ترجمة “التوطين” فقد تتعدّى على الأصل.
وقد يصعب توضيح ما يعنيه هذا بشكل عملي. فما مقدار الثقافة العامة التي يمكنك افتراضها لدى قارئ؟ ليست هناك حاجة لترجمة “الغولاش” إلى “حساء اللحم بالبابريكا” فيما يلاحظ سيرلز. لكنني قرأت آلاف الصفحات من الأدب النرويجي وما زلت أجهل ما تعنيه لوتفيسك [lutefisk] فعلًا. والأسلوب مشكلة أصعب. فمن الواضح أن استخدام الجملة الواحدة المكلكعة في “السباعية” تطرُّف مُتَعَمَّد. لكن ما مقدار الطول الذي تحتاج إليه الجملة المُترجَمة عن بروست حتى تصبح بروستيّة دون أن تصبح فاسدة؟ ماذا تفعل بالحوار، أو النكات البذيئة؟ ما المقدار الذي يجعل الترجمة مبالغًا فيها؟
يحب الباحثون تذكيرك بأن إحدى مرادفات اللغة الإغريقية القديمة للترجمة هي metaphora [المجاز]. الترجمة مجاز، وقد تقع في فخ الأطر المفاهيمية المُستخدمة في وصفها. إليك على سبيل المثال الإيحاءات العسكرية للمصطلح الشائع “اللغة المُستهدَفَة”. أو تأمل فكرة الترجمة “الأمينة”، التي تتضمن، كما كتبت إميلي ويلسون، أن الترجمة مؤنثة چندريًا، وأنها قد تخون الأصل المذكر (ولذلك تستخدم العبارة الإيطالية traduttore، traditore، “خيانة الترجمة”). وفي “دون كيخوته” يقارن ثربانتس بين قراءة ترجمة و”النظر إلى إحدى النُجود الفلمنكية من الجانب الخطأ” حيث “جمال العمل ودقته مطموسان”.
يسعى سيرلز إلى تعديل هذا الوضع، فيجد ضالته في دراسة الظاهرة. وبمصطلحات دراسة الظاهرة، ليس هناك فاصل بين العقل والعالم: إنهما متشابكان. يقدّم سيرلز المثال المريح لكرسي. عندما ترى واحدًا فإنك لا “تواجه ‘بيانات حسّية’ كما يحب الفلاسفة أن يقولوا، فيعالجها حاسوب مخك الفائق عندئذ”. بل ترى ببساطة “مكانًا للجلوس. هذا هو رؤية كرسي”. إنك تميز كرسي على أنه شيء تجلس عليه. هذا هو “الإيحاء الوظيفي” [affordance] كما يقول سيرلز، مستعيرًا مصطلحًا صكّه عالم النفس الأمريكي چيمس چ. جيبسون، الذي تصوّره خلال الحرب العالمية الثانية، وهو يدرس كيف يدرك الطيارون المقاتلون بيئتهم. ولأسلوب الإدراك هذا فائدة تحطّم الفارق بين النفس والعالم: لا يوجد أي كرسي بكل ما يحمله من كُرسِيَّة دون مُدرِكٍ يراه باعتباره شيئًا يجلس عليه، الكرسي هو إيحاء وظيفي لمكان جلوس.
ما علاقة هذا بالترجمة؟ القراءة، كما يشير سيرلز، هي شكل من أشكال الإدراك، والنص يشبه إلى حد كبير عالَمًا. تُقدِّم الكلماتُ والعباراتُ فيه إيحاءاتٍ وظيفية، فيلتقطها القراء في طريقهم. والمترجم إذن لا يتنقّل بين المفردات فحسب، مفسرًا كلمة واحدة في المرة. بل هو قارئ يعيد تشكيل مساره الخاص خلال عالم الكتاب النصّي. يقرر سيرلز أن “كل المعضلات الفلسفية عمّا إذا كانت الترجمة ‘تعكس’ أو بخلاف ذلك ‘تحوّل’ ما في الأصل، ينبغي تنحيتها جانبًا”. يرى ميرلوبونتي، فيما يكتب سيرلز، أن العالم لا يُوجد أو يُخلَق من خلال التجربة، بل يُكشَف ويُعالَج، كما لو أنه صورة ضوئية. ويقترح أن الترجمة تفعل شيئًا مشابهًا، “معالجة” الأصل كما لو أنه الصورة الضوئية السالبة [negative].
إذن، عمليًا يقرأ المترجم بغرض فهم الإيحاءات الوظيفية التي يقدمها نص، ليعيد تشكيل إمكانيات هذا النص، وليس مجرد طرح المفردات المعجمية المقابلة. يكتب سيرلز “نحن لا نترجم كلمات لغة، بل نترجم استخداماتها”. فالمقصد ليس التقاط ما يعنيه النص فحسب، بل إعادة إنتاج كيف يعني ما يعنيه في سياقٍ ما. في إحدى محاولات سيرلز لوصف هذا، يستعير مصطلحًا من جيرترود ستاين، هو “قوة” النص. ويكتب “ما يبدو في أي ترجمة كاختلافات أو أخطاء واضحة على مستوى المفردة الواحدة، قد يكون جزءًا مما تحتاج إلى فعله لإعادة تشكيل القوة نفسها في الإنجليزية”. ويشير إلى إعادة ترجمته كتاب ماكس فيبر “العلم والسياسة بوصفهما حرفة” [Vocation Lectures]، الذي خرج للجمهور العام بين 1917 و1919، وهو عمل ملآن بالأفكار، صحيح، لكن به كثير من الصور البلاغية أيضًا. في إحدى الفقرات، تنص ترجمة سابقة على “يمكننا أن نرى بوضوح شديد أن آخر التطورات تتحرك في الاتجاه نفسه مثل…” (Nun können wir . . . mit Deutlichkeit beobachten: daß die neueste Entwicklung . . . in der Richtung der [X] verläuft). بينما يختصرها سيرلز إلى “الاتجاه الواضح إنما هو نحو…” ويعتقد أن هذه النسخة تفي بما يقدمه الأصل: فهي تنقلنا من فكرة إلى أخرى برطانة أكاديمية مُقنِعة. لكنها تفعل ذلك بطريقة ربما استخدمها فيبر لو كان يلقي كلمته بالإنجليزية اليوم، بدلًا من نقل طريقة ألمانية من بداية القرن العشرين إلى الإنجليزية.
تصوُّر اللغة على أنها شيء نغازله ونتعارك معه، وليس كلمات جامدة يضمها قاموس، يساعدنا أيضًا على حل سؤال حفلات السَّمَر عمّا إذا كان بالإمكان ترجمة كل شيء. كيف تتصرف مع مُرَكَّب ألماني بثلاثة فوّهات، أو المصطلح الخرافي التاسع والأربعين للثلج في لغة الإسكيمو؟ يروي سيرلز قصةً في هذا السياق عن حوار أجراه مع المسرحيّ النمساويّ كليمينس بيرجر، الذي أخبر الجمهور عن كلمة (mamihlapinatapai) من لغة السكان الأصليين (الياجان) في جنوب باتاجونيا. أوضح بيرجر أن الكلمة تشير إلى “طيب، عندما يوجد رجل وامرأة في بار، وينظر إليها، وتنظر إليه، وينظر كلاهما إلى الآخر ونظراتهما تقول إنني أشعر نحوك بالاهتمام لكنك بحاجة إلى اتخاذ الخطوة الأولى والقدوم إلي؟ هذا هو ما تعنيه الكلمة.” ضحك الجمهور، لكن سيرلز أشار إلى أن الكاتب المسرحيّ في الواقع، وهو يشرح كيف أن mamihlapinatapai لا يمكن ترجمتها، قد ترجمها فعلًا: إن مفردة واحدة لا تستوعبها، لكن المصطلح قد أنجز ما يُفترض به إنجازه. التفكير بهذه الطريقة يترك المترجم ليشق طريقه، أو يتجاهل ببساطة كثيرًا من المشكلات المعقدة.
فلسفة سيرلز في النهاية تتبنى الحرية، أن تمضي أبعد من مجرد المرادف، أن تترجم الطريقة التي يتواصل بها نص وليس ببساطة ما يقوله. بكلمات أخرى، الحرية اللازمة لفعل ما يفعله مترجمو الأدب البارعون حتى الآن. قد يجد البعض هذا التحرر مدهشًا، بل وخطيرًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بنصوص لا يتوقف معناها على نتاج تجربة القارئ المحضة، بل يوجد بشكل وثيق في صميم البنية اللفظية الدقيقة. (أحد الفلاسفة وهو يقدّم عرضًا لنسخة سيرلز من كتاب فيتجنشتاين “رسالة منطقية فلسفية” لاحظ أن “سلاسة” المترجم الكاشفة من حين لآخر قد تؤدي إلى “ترجمة خاطئة بلا ريب في بعض الأحيان”.) لكن سيرلز يرى ألا مفر من أن تكون أي ترجمة تجربةً ذاتية في عُمقها. ويكتب “كل المترجمين أمناء، لكن لأشياء مختلفة: لما يشعرون أن الاحتفاظ به هو الأهم أيًا يكن”. قد يكن ذلك الشيء كبيرًا بقدر السياسة الچندرية في الأوديسة، أو صغيرًا بقدر الحرف الأخير الذي يشبه ذيلًا لاعبًا في نهاية اسم براجي.
إنها إذن أيضًا فلسفة ثقة. فلا بد أن يثق القراء بوعد المترجمين أن تكون النسخة المُترجَمة على صلة بالأصل، والمؤلفون- حسنًا، على المؤلفين الاستعداد والانتظار فحسب. يحتاج المترجمون أيضًا إلى الوثوق بأنفسهم، والالتزام بنقل تجربتهم لرواية أو مقال أو قصيدة، بدلًا من محاولة إخفاء أنفسهم في منطقة حيادٍ بين اللغات. في الحقيقة، إن الظهور قد يكون مفتاح نجاتهم في ظل تطوُّر أنظمة الترجمة المُوجَّهة بالذكاء الاصطناعي، وتجاوزها مجرد صيد المرادفات الذي تنجزه أدوات مثل ترجمة Google. وكما هو الحال غالبًا، فالذكاء الاصطناعي لا يغيّر قواعد اللعبة بقدر ما يُضخّم من فاعلية قائمة أصلًا: الترجمة الجيدة تستمد من الحياة والتجربة والشخصية بقدر ما تستمد منها الكتابة الجيدة. يُحكى عن روبرت فروست أنه قال “الشعر هو ما يضيع في الترجمة”. لكن سيرلز قد يقول إن ذلك لا يكون صحيحًا إلا إذا ضاع فيها المترجم أيضًا.