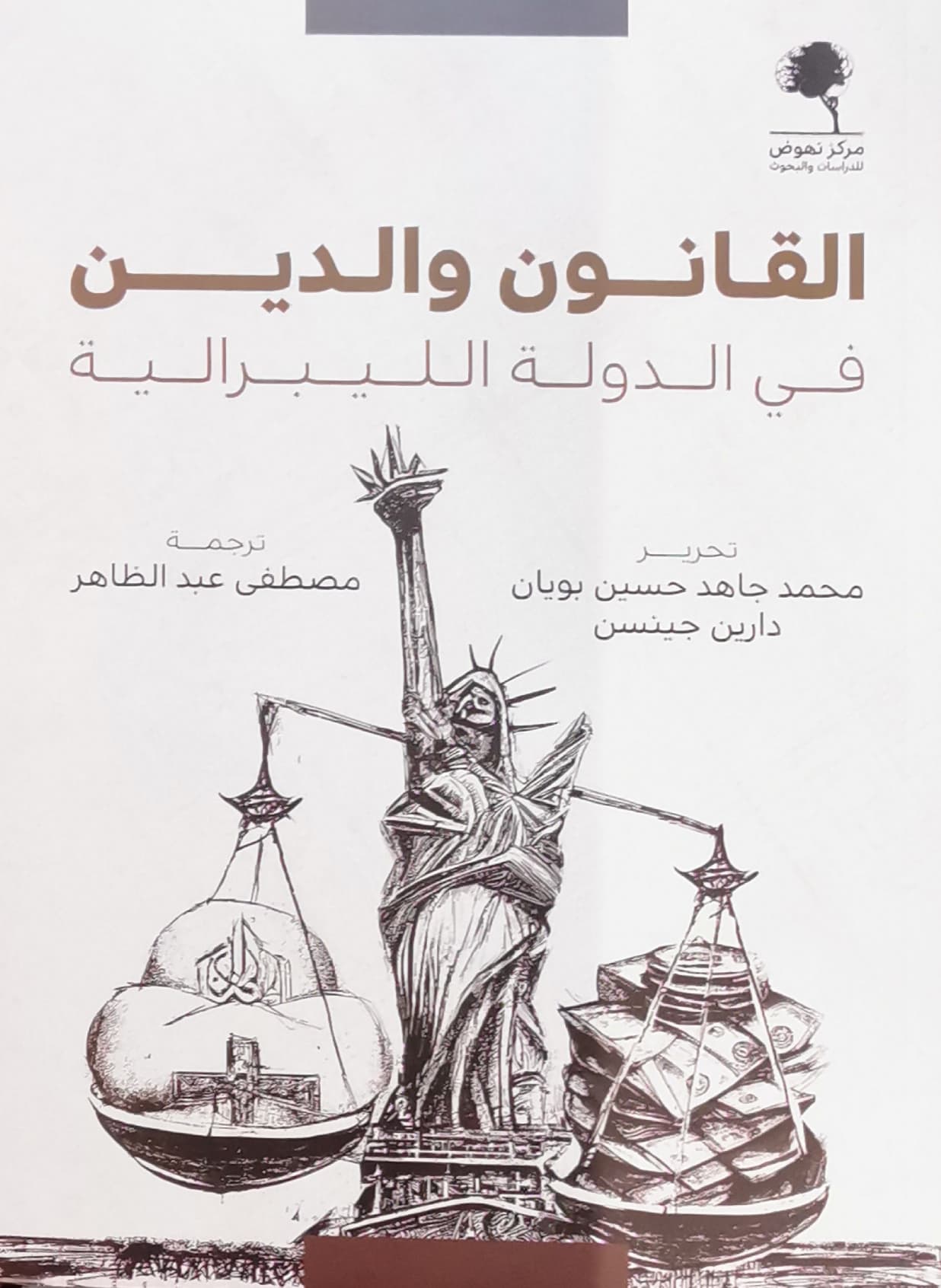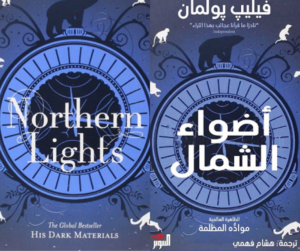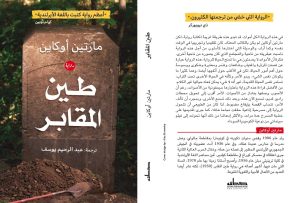نتحدث مع المترجم مصطفى عبد الظاهر في هذا الحوار عن تجربته في ترجمة كتاب “الدين والقانون في الدولة الليبرالية” من تحرير محمد جاهد بويان ودارين جينسن الصادر حديثًا عن مركز نهوض للدراسات والبحوث. مصطفى باحث ومترجم مصري، متخصص بالقانون، وتتوزع اهتماماته بين العلوم الاجتماعية والدراسات ما بعد الكولونيالية ودراسات الشرق الأوسط وتاريخه. ترجم العديد من الأبحاث والدراسات مثل: مساءلة العلمانية: السياسة والسيادة وحكم القانون في مصر الحديثة، تأليف حسين علي عجرمة، وفي ظلال الغد، تأليف يوهان هويزنجا، النازية كعقيدة حقد، تأليف مينو تير براك.
هل يمكنك أن تقدم لنا نبذة عن الكتاب ومؤلفه؟
هو عمل جماعي من تحرير محمد جاهد حسين وبيان ودارين جينسن، الأول أستاذ مساعد في القانون ببنجلاديش والثانية محاضرة في القانون بالجامعة الوطنية بأستراليا، ويضم الكتاب 17 دراسة لباحثين من دول مختلفة حول العالم، تتناول موضوعات تاريخية ومعاصرة حول علاقة الدين بالقانون في الدول الليبرالية. ولا شك أن تعريف الدول محل الدراسة بالدول “الليبرالية” قد حمل دلالة خاصة وأساسًا نظريًا لهذا العمل، فوضع كرواتيا وجمهورية الجبل الأسود إلى جوار الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا إلى جوار الهند وجنوب إفريقيا يثير سؤالًا مباشرًا لدى القارئ: ما الظرف التي تشترك فيه هذه الدول جميعًا على اختلاف مواقعها وثقافاتها واوضاعها الاقتصادية وبنيتها التاريخية وأنظمة حكمها وتكوين مجتمعاتها؟ الإجابة التي اعتمدها الكتاب هي أن القانون الحديث ليس مجرد مجموعة من القواعد تختلف من بلد لآخر حسب أوضاعه، بل هو “تقليد قانوني” له تكوين منطقي وشروط اجتماعية وسياسية وثقافية – من بينها الدين – يمكن تلمس هذه الملامح وما تثيره من إشكالات في كافة الدول المذكورة وغيرها. ومن هنا، يأتي دور الاختلاف ووجاهة منطلق الدراسة: إذا كانت ثم بنية للتقليد القانوني الحديث قد استمدت تماسكها وشرعيتها من مفاهيم مثل الدولة والفرد والمواطنة وحرية الضمير والعلمانية.. إلخ. فما العوامل المؤثرة على تطبيق القانون وممارسته وفيم تختلف من مجتمع لآخر؟
لماذا اخترت هذا الكتاب لترجمته؟
ترجمة الكتاب كانت باقتراح كريم من الناشر “مركز نهوض- الكويت” وهو مركز أبحاث ودار نشر تعنى بالأساس بالأعمال التي تدور حول القانون، وأنا تحمست للكتاب بالطبع لأنني مهتم أيضا بالقانون وهو موضوع دراستي في مرحلة الجامعة، فقد تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ولي اهتمام علمي بعلم الاجتماع وانثروبولوجيا القانون والدين ونشرت فيهما عدة أبحاث، اكن اهتمامي انصب لفترة طويلة على الأسئلة النظرية وعندما اطلعت على الكتاب وجدت فيه اختلافا مفيدًا عن اهتماماتي النظرية؛ ذلك أن دراساته تنضوي تحت توجه وصفي وتحليلي للقضايا والإشكالات القانونية، وهو ما رأيت فيه فائدة كبيرة للمكتبة العربية. وفيم أرى يفتح الكتاب للقارئ نافذة واقعية للنظر في أسئلة يحسبها الكثيرون محسومة، من بينها الأثر الكبير للدين على أكثر القوانين علمانية في أوروبا والولايات المتحدة، والمشكلات التي تظهر من النزاع بين مفهومي العلمانية وحرية الضمير، وغيرها من الإشكالات المتعلقة بصعود اليمين في اغلب دول العالم وأثر ذلك على حقوق الأقليات الدينية، واغلبها مشكلات تهم القارئ العربي وتؤثر على حياته.
ما التحديات التي واجهتها أثناء ترجمة الكتاب؟
الحقيقة كما ذكرت سابقًا الكتاب يتبع منهجًا تحليليًا ولغة بسيطة ومباشرة، لكن التحدي الرئيسي هو ما يواجهه كل مترجم حين يشرع في نقل عمل جماعي إلى لغة أخرى: اختلاف الأصوات وطرق السرد. وأنا يهمني كثيرًا في عمل مثل هذا ألا تغلب طريقتي في الترجمة أصوات المؤلفين وطرقهم في الكتابة.
ما الذي جعلك تتجه لمهنة الترجمة؟
قد أكون كاذبًا لو قلت أن الترجمة كانت قرارًا واعيًا محضًا مني. أنا بدأت بالاهتمام بالشأن العام، بالسياسة والاجتماع والثقافة، في وقت مبكر من حياتي، ومع سعيي لتعليم نفسي رأيت كما يرى كل أبناء جيلي قلة الإنتاج العربي في هذه الموضوعات. أذكر مثلا بعد الثورة أنني كنت أسأل أساتذة في السياسة والاجتماع والقانون عن كتاب يمكن قارئته كمدخل للنقاشات النظرية حول مفهوم “الدولة”، لا أذكر العنوان بالتحديد لكنه كان كتابًا واحدًا، مؤلف في الخمسينيات ومترجم في الثمانينيات ونافذ من الأسواق ولا نجد نسخة لدى ناشره نفسه. طبعًا علمت بعد ذلك أنه كان هناك عدة كتب، لكنها قليلة جدا، ومن تقاليد وتوجهات نظرية محددة. لذلك بعد أن تعلمت وقرأت لفترة سعيت عند عملي مع مركز نماء للدراسات والنشر، وبسعي كريم من القائمين عليه آنذاك الدكتور ياسر المطرفي والأستاذ أحمد سالم، أن نترجم أعمالا تستهدف سد ثغرات في المكتبة العربية في حقل العلوم الإنسانية، والحمد لله حققنا إنجازا في ذلك، فساهمت كمترجم ومحرر ومراجع منذ ذلك الحين على هذه الطريقة إلى جوار عملي البحثي ككاتب وكمحرر.
ما التحديات التي يواجهها المترجم إلى العربية؟
المترجم يعاني مما يعاني منه قطاع إنتاج الثقافة عموما في العالم العربي، وهي أحوال غنية عن التوصيف ويراها كل أحد. هذا بخلاف الأوضاع المهنية والمالية الهشة للمترجم والكاتب على حد سواء. إلى جوار ذلك أرى أن هناك مشكلة كبرى في ترجمة العلوم الإنسانية الغربية إلى العربية وهي أنها لم تستقر على معجم واحد، هناك قطيعة حدثت بين جهود الترجمة في هذا الحقل التي بذلت في العقود السابقة، والجهود المبذولة حاليا؛ ليس هناك تراكم ينتج تجذرًا لهذه العلوم في اللغة العربية مما يعين الثقافة والأكاديميا العربية على تشربها والمساهمة في إنتاجها، هناك عناصر شتى مساهمة في هذا الأمر منها غياب العمل المؤسسي والمشاريع المتكاملة، وصراعات الهوية حول طبيعة اللغة العربية ودور الفصحى والعامية.
هل يمكنك أن تصف لنا طريقتك في الترجمة، مثلًا كم مسودة تعمل عليها؟ وما القواميس والمراجع التي تعتمد عليها؟
من حيث المنهج، أنا في الواقع أميل لطريقة ديمقراطية جدًا، لا سيما في الأعمال النظرية، أقول “كلما ضاق الأمر اتسع” فكلما صعبت المفردة أو المصطلح في اللغة الأصلية، ملت إلى التيسير والمباشرة وأكثر المرادفات شيوعًا، طبعًا مع مراعاة المستقر وتقدير الجهود السابقة، لكنني أجتهد بحسب الطاقة إلى تيسير سبيل فهم الكتاب لكل القراء والمهتمين. من الناحية العملية، أعمل بطريقة عادية، واستشير العديد من المراجع صففتها في آلية تقنية -بدائية بعض الشيء – من المراجع المتخصصة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية، أظنها بلغة الآن 17 مرجعًا. وأراجع كل فصل بعد إتمامه، ثم أراجع العمل كاملًا بعد الانتهاء.