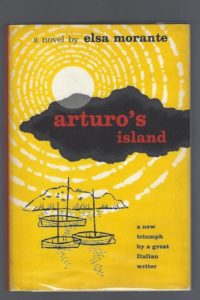مقال جوشوا سبيرلنج
ترجمة: محمد السعيد
* نشر في موقع بابليك بوكس، 17 سبتمبر 2021
الترجمة خاصة بموقع ترجمان
في مقالةٍ منشورةٍ عام 1959، تصوّر الناقد الفنّي جون بيرجر خمس طرق في النظر إلى شجرة: كفيلسوف، ومهندس، وشاعر، وعاشق، ورسام. المهندس يقيس ويعد؛ العاشق يتشاعر؛ الفيلسوف يستنبط. الرسّام يدرس تألّق الألوان وموضع الأغصان —«مثل خيّاط ملابس، لا عالم رياضيات» يوضّح بيرجر. المقصد أنّ كل نظرة تتبعها خاطرة ذهنية مختلفة، فيصبح النظر نوعًا من النشاط، وكل «طريقة نظر» صلةٌ فريدة بالعالم.
فلنتخيّل خمس طرق ننظر بها تجاه قراءة كتاب. يمكنك قراءته كمدقّق، أو مُستَمتِع، أو مراجعٍ عجول، أو باحثٍ يريد إثبات نظريةٍ للحفاظ على منصبه. في بحرِ هذه الطرق اللامنتهية للقراءة، نجد النشاط البارز الذي دعاه ديمين سيرلز «القراءة كمترجم». وفقًا لهذا المترجم غزير الإنتاج وذائع الصيت، يضع هذا النمط من القراءة الترجمةَ بمنأًى عن المساعي الأدبية الأخرى، إذ تفتح أبوابًا فلسفية لفهم جوهرها فهمًا حصيفًا.
الترجمة ليست نشاطًا قرائيًّا وحسب، بل تفاعليًّا أيضًا. هذه رسالة الترجمة وكُنّها: رحلة القارئ من التكوين إلى المعرفة إلى الفعل، متداخلةَ الحدود. مع هذا، فإنّ هذه العمليّة بالذات —عرقلة الوعي الأدبي والنشاط القرائيّ— النقطةُ العمياء لمنظّري الترجمة مع هوسهم بما يجب فعله وما لا يجب.
ونظرًا لهذا، لاقت فكرة سيرلز حفاوةً كبيرة. في العديد من المقالات والحوارات، ومنها محاضرة مطولة لمبادرة الترجمة في جامعة ييل، بنى سيرلز —الذي اشتُهر بترجماته في كلاسيكيات نيوريورك ريفيو بوكس من الألمانيّة والفرنسية والدنماركية للكتب التي تتناول موضوع الحداثة— منظومته الفلسفيّة الخاصّة بنسقها الجدلي والتصحيحيّ. أبرزها، محاولته في الانتقال من الكتابة (إنتاج النص المُترجَم) إلى القراءة (تشرّب النص الأصلي)؛ ليبثّ الحياةَ بقوّةٍ في إحساسنا بالأخيرة.
الكتابة كمترجم —وفقًا لسيرلز على الأقل— ليست مختلفة عن الكتابة المحضة: أنْ تختار الكلمات الأنسب بما يتوافق مع غايتك. وإنما يحدث تغيير ما عند قراءتك كمترجم.
يقول سيرلز في مقالة قصيرة بعد نشر كتاب أيام الذكرى السنوية Anniversaries ليُوِيْ جونسون: «تعني القراءة كمترجم… القراءة مع الانتباه إلى الوسط [الأدبي].. كيف لهذا النص أنْ يساوم على الافتراضات المُضمّنة في اللغة الأصلية؟ ليس عليك أن تترجم لتقرأ كمترجم —حتى القارئ أحاديّ اللغة يمكنه فعل هذا— هذا إن امتلكت لغة أخرى لتباين وتقارن معها، أما الافتراضات اللغوية المضمنة ستبقى على الأرجح خافيةً عنك».
سيرلز ليس سفسطائيًّا، بل مثله مثل هوسرل وهايدجر وآخرين من التيّار الوجودي، يريد أن يضمّ الفلسفة إلى التجارب الحياتيّة من جديد. يمكن للمرء أن يتحدّث عن نظرية أو ممارسة تخدم غاية معيّنة: مثل تسلق الصخور أو الطيران أو الحياكة. لكن يبقى هناك شيء ثالث: كيف لمتسلق صخور أو طيّار أو حائك أن تتغير علاقاتهم مع الصخر أو الهواء أو الملابس، وكيف لتلك العلاقة القويّة أن تكشف حقيقة أكثر عمومية عن مكانتنا في العالم.
إذن، ما ستكون النظرية المثلى للترجمة؟ كان جورج شتاينر محقًّا عندما قال إن المثقّف من يقرأ وفي يده قلم. العمل كمترجم يعني الاصطدام بنصٍّ، مملوءًا برغبةٍ حيّة، رغبة تؤسس وترمّم تجربة ذلك النصّ.
ما ندعوه نظريّة الترجمة، من نصوص ونقاشات، وهي ترافق أعمال المترجمين مرافقةَ الظلّ. من جدال القديس جيروم مع أوغسطين في القرن الرابع حتى المشاجرات التويتريّة التي تناولت قضيّة المترجمة الفوريّة الدنماركية لأماندا جورمان، وغالبًا ما تتمحور حول أفضل الممارسات للمترجمين: ما يجب فعله وما لا يجب. كيف ينبغي أن تُترجم «free» أو «pious»؟ أو «difficult» أو «self-effacing»؟ من له الحقّ في الترجمة؟ وما الخطوط الحمراء —والخضراء؟
بغض النظر عن النزعات الإرشاديّة، لا ننسى أنّ ميتافازيقيّي الترجمة موجودون أيضًا —بدءًا بفريدريخ شلايرماخر حتى فالتر بنيامين، مرورًا بخورخي لويس بورخس إلى غاياتري سبيفاك. مع هذا، فإن غالب نظرية الترجمة تركز على المعايير سواءً وظّفت مصطلحات جماليّة أو دينيّة وما يشابهها؛ إذ بُنيَت كل المدارس تقريبًا على أسس ثنائية متقابلة: الذاتي والموضوعي، اللغة المصدر واللغة الهدف، المترجمون والنص، العالم وصورته.
وفقًا لسيرلز، هذا الفكر الثنائي قاعدة فلسفية تحرّف أو على الأقل تشوّه عمل المترجم حينما نتلقّاه فعلًا (في عزّ سيرته المهنة، ترجم سيرلز ما يقارب الثلاثين كتابًا). يتجلّى هذا الاستياء في جنوح مارك بوليزوتي عن نظريّات الترجمة. يرفض بوليزوتي كل هذا التنظير لدرجة أنه يكاد يرفض هذا التيار الفكري نفسه لصالح «منهج الحسّ المشترك» في الترجمة، فينبغي أن تكون «قدماك مغروستين في الميدان». لا يريد سيرلز التخلّي عن النظريّة، لكنّه يريد إقرارها —وتصحيحها—؛ لبعدها عن الواقع.
من المصطلحات المهمّة للفينومينولوجيين: «المقصد». أن نتلقّى موضوعًا ما ليس كانطباع صورته على دماغي، بل علاقة الموضوع بالصورة في شدٍّ وجذب، رقصة مشروطة بالمستقبلات العصبيّة والبيئة الخارجيّة.
ثمّة بدهية مشابهة في التقويم الفلسفي الذي طرحه سيرلز حيث لا يُستمدّ من نظريات اللغة بل من الإدراك. جزء من كلمته في جامعة ييل، يناقش سيرلز فيه أن فهم المقروء مقرون بالإدراك أيّما اقتران.
ليس لأن القراءة عمليّة حادثة من إحدى الحواس (سواء بالنظر إلى الحبر على الصفحة، أو البكسلات على الشاشة، أو الاستماع إلى كتاب صوتي)؛ وليس لأن قراءة كتابٍ جيّد تغيّر من نظرتنا تجاه العالم كما يُقال. على نحوٍ أولى، لأنّ جهازنا الإدراكي أثناء عمليّة القراءة معتمدٌ حتمًا على طريقته في بناء العلاقات لأيّ شيء. حينما تتبّع سيرلز مغالطة الذاتي-الموضوعي إلى جذورها، استذكر مفكّرَين غالب فكرهم يتناول التجربة البصريّة فضلًا عن المعاني اللغوية والأدبية: الفينومينولوجي الفرنسي موريس مارلو-بونتي وعالم النفس التجريبي الأمريكي جيمس جيبسون.
كلاهما أراد تفكيك هذا المنهج الإدراكي الثنائي في علاقة العقل بالجسد السائد منذ عصر ديكارت. بدلًا من النقاش في الانقسام الجليّ بين العالم الخارجي «ما في الخارج» والتمثيل الصوريّ في العقل «ما في الداخل»، تكلّما عن حيوانٍ يتحرّك ويعمل في بيئة تفاعليّة. كان الإحساس هو فكرة مارلو-بونتي الرئيسة مع معانيه المركّبة —طبقات يبنيها سيرلز ويظهرها. في الفرنسية، لا تشير sens إلى الحواس فقط، بل إلى نوعٍ من الرأي، أو إلى انطباعٍ دلاليّ؛ وأيضًا تشير إلى الاتجاه (مثلًا، طريق ذهاب فقط، يُقال في الفرنسية: à sens unique). هذا المعنى الأخير كان مهمًّا لمارلو-بونتي؛ فرآه كتذكيرٍ أنّ الإدراك يميل أن يكون وجهة وليس نقطة —دائمًا موجَّه، متحرّكٌ في اتّجاهٍ محدّد، كانت هذه فكرة عسيرة الاستيعاب على التيّار التحليلي.
مشتغلًا بعيدًا عن المنافسين البيزنطيين في الفلسفة الفرنسية، درّس جيمس جيبسون علمَ النفس في كلية سميث بجامعة كورنيل قبل الانضمام إلى الجيش الأمريكي حيث دَرَس نظر الطيّارين المقاتلين إبان الحرب العالمية الثانية. عُرفت النظرية التي كوّنها جيبسن «النظرية البيئية للإدراك» أو «المقاربة البيئية». جيبسون، مثل مارلو-بونتي، رأى أنّ الإدراك عمليّة نشطة أكثر مما تُفهم، دائمًا منوطة بنوايانا ورغباتنا وإمكانياتنا، ومن ضمنها سعينا إلى تجويدها (كانت زوجته إلينور جيبسون إحدى السبّاقات في مجال التعلم الإدراكي). بدلًا من الإحساس sens، تحدّث جيبسون عن «المِنَح»، أو ما تمنحه البيئة للكائن المُدرِك —هذه الإشارات المرتبطة بمهمة محددة، سواء أكانت نافعة أم ضارّة. بدلًا من تلقّي صورة ثابتة، يسعى الكائن إلى المعلومات تحت ما يسمّيه «شعاع بصري»، يدخل ويخرج من الدوائر العصبيّة.
وفقًا لجيبسون ومارلو-بونتي، إنّ الإدراك عمليّة. أن تدرك يعني أن تتفاعل مع بيئة ضمن إطار زمني.
ما أن تبدّل «يدرك» بـ«يقرأ» حتى تملك نموذجًا طازجًا لنظريّة الأدب. لا يؤدّي المترجم عمليّةً تجريديّة، بل يسبح في بحر النصّ، فيَصل لمختلف بقاعه، مكتسبًا شيئًا فشيئًا أُلفةً في شوارعه حتى يحيط بتياره الأدبي ومكنوناته اللغوية.
رجوعًا لتلك المشاكل الأسلوبيّة الشائكة التي يحب المترجمون مشاركتها، يبدي سيرلز أن ما فعله لا يخرج من كونه بحثًا عن تلك المِنَح التي استفاد منها المؤلف في لغتِه؛ إذ كتب «عملية وفنّ الترجمة لا يتعلّقان بالكلمات تعلّقًا رئيسًا، بل يتعلّقان بلغتك كلّها، وبما فعل المؤلف بلغته كلّها —وأحيانًا بإعادة النظر أو إعادة التصوّر بما كانت عليه تلك اللغة».
لطالما كانت قوّة وضعف المقاربة الفنومينولوجية في ذاتيّتها، إذ لا حقيقةَ لها خارج تجاربنا الشخصيّة. بالنسبة إلي، بوصفي مترجمًا غير دائم، فإنّ أفكار سيرلز في محلّها. إن شعرتُ بالرغبة في ترجمة نص (عادةً قصيدة)، فلأنّي أريد الانغماس في تلك العلاقة العكسيّة كما وصفها سيرلز.
مثلًا، في الربيع الماضي، خلال الحجر الصحّي، عدتُ لمسوّدات ترجمتي لشاعر منتصف القرن العشرين، الإسباني خوسيه يِيرّو. كانت البيئة جزءًا مما فتنني (وربّما كنوعٍ من الهروب): عادةً ما تصوّر قصائد ييرّو الساحل الإسباني بنخيله وشمسه الساطعة وبَحرِه الدافئ. لكن في هذا القيظ، رجلٌ مكتئب، أُطلق سراحه من السجن إلى دولة أعيتها الحرب لدرجة أنّه لم يعد يألفها. يُشار إلى الحزن إشارةً صريحة، لكنّه أيضًا مضمّنٌ في اللغة نفسها، وفي حنين ييرّو إلى بساطة متناغمة. الامتناع في قصيدة «Olas» («أمواج»)، قصيدة لطالما عدتُ إليها، امتناعٌ خادع:
“Esta alegría que ahora siento / yo sólo sé lo que me cuesta”
هذه البهجة التي أشعر بها الآن / وحدي أعرف تكاليفها.
علاوة على المدّ في الشطرَين، في تبادلهما لصوت (o) وصوت (a)، ووزنهما الشعري، أراد ييرّو وضع العاميّة الإسبانية في (“me cuesta”) موضعًا غير اعتيادي، في ابتذالٍ وروحانيّة. ستترجم “Me cuesta decir” إلى «يصعب عليّ قول هذا»، لكن هنا، alegría الخاصّة بالشاعر، بهجته، حمّلته ما لا يطيق.
الكثير من نظريات الترجمة تتناول ما ينبغي وما لا ينبغي. هل عليّ إظهار «الغُربة» أو إنتاج شيءٍ «منساب»؟ أيًّا ما كانت المعايير، فإنها ليست ما دفعتني إلى الترجمة في المقام الأول. وردتُ إلى قصيدة «Olas» لأنني كنتُ أبحث عن تجربة أدبية لا تمنحها إلا الترجمة —لربّما بها أستشعر ما تكون تلك المعايير النهائية. قررتُ في قضيّة ييرّو أن أراها بعينَي إسبانيّة بسيطة عن قصد —على لسان حال قشتالي ناجٍ من الحرب وسجينٍ سابق عَنَت إليه مسرّات الطبيعة البسيطة راحةً وخزيًا في آن— وأنا أتأمّل عن قرب تجربتَينا في حجر كوفيد-19 في ذلك الربيع.
كنتُ وأنا أتنقّل بين نص ييرّو الأصلي وترجمتي في حالةٍ أدبيّةٍ فريدة. من جهة، كنتُ ببساطة «أفعل أشياءً بالكلمات» (كما يقول الفيلسوف ج. ل. أوستِن)؛ ومن جهة أخرى، كنتُ في «لعبة لغويّة» (كما يقول فيتجنشتاين). لكن أفعالي ولعبتي مشروطتان بغايتي —أن أترجم قصيدة أرتضيها. «مقاومة» الأصل شبيهة لاستجابة المتسلّق إلى صخرة أو قطعة لباس إلى خيّاط. كان الوسط، أو البيئة، مشجّعًا لبعض الأفعال، مانعًا لبعضها، حتى أنّ محاولاتي لترجمة القصيدة كانت عبارة عن مفاوضات لتجربة مستمرّة.
ماذا تعني مقاربة سيرلز الجديدة لتاريخ طويل من التنظير والممارسة في حقل الترجمة؟
تقول الإجابة التخصّصية أنها لربما ساعدتنا في إبعاد دراسات الترجمة عن المدارس البنيويّة والتفكيكيّة وما تفرّع منهما، واللتَين قيّدتها لعقود طوال. إن اللغة في هذه التيّارات بُنيَة وليست عمليّة، فالكلمة، وفقًا لها، عملة قابلة للاستبدال ورمز، وليست سِيرة، دائمًا منوطة بأضدادها، ذات حمولة فكريّة.
تنظر النظرية الفينومينولوجية في حقل الترجمة تجاه النص بوصفه متعدد الأبعاد، فالعمل الأدبي ليس مصفوفة من العلامات، بل امتدادًا للتوجّهات والعلائق التي يمكن رؤيتها والإحساس بها. تمتاز ترجمات سيرلز بأنها تمسّ الكثير من المواضيع: ثمّة محاضرات فيبر ونيتشه، ورسائل ريلكه، ويوميّات هانز كيلسن، ومذكرات يوي جونسن، ومقالات بروست التمهيدية، بالإضافة إلى الروايات والتراجم والتاريخ.
تحمل كل واحدة منها نسقها وقصدها الخاص. أحيانًا حرفيّة وعموميّة (كالمحاضرات العامّة)؛ وغالبًا اجتماعيّة وخياليّة، تستخدم لغة جديدة في كلّ مرة.
ستختلف ألمانيّة عالم اجتماع مسن قبل الحرب العالمية الثانية عن الألمانية الموجودة في مفكّرة يهودي مختبئ في دلفت إبان الحرب العالمية الثانية، وهو منغمس في علاقة خارج إطار الزواج، إذ سيحاول تبييض لغته. كلاهما سيستعملان اللغة استعمالًا مختلفًا عن مترجمٍ في لقاء افتراضي من غرفة معيشته في عام 2020.
أن تقرأ كمترجم، يعني لي، أن تعود إلى الينابيع اللغوية، أن تقدّر تدفّق الاحتمالات من سكون الكلمات. وقراءة أعمال سيرلز بعد معرفة نظريّاته دعوة إلى طريقة جديدة في القراءة.
اشتهر بروست في فكرته أن القراءة طريقة تواصل مع الآخر مُحافِظة على قدسيّة العزلة. أثناء قراءتي لترجمات سيرلز الأخيرة، حدث شيءٌ ما: صار الحديث حوارًا عالميًّا متعمّقًا، من رقصة ثنائية إلى ثلاثيّة. في أفضل أعماله، بمباشرة حيّة مع اللغة الألمانيّة الفلسفية، يظهر النص كما لو أنه لوحة مُرمّمة للتو، فلا تألف تلك الغرابة الجديدة بسبب رؤية الفنّان فقط بل بسبب رؤية المُرمِّم أيضًا. النتيجة كالطِّرس الشفّاف؛ فينومينولوجية سارّة ومنوطة بالقارئ الذي تعتلج في عقله المتناقضات.